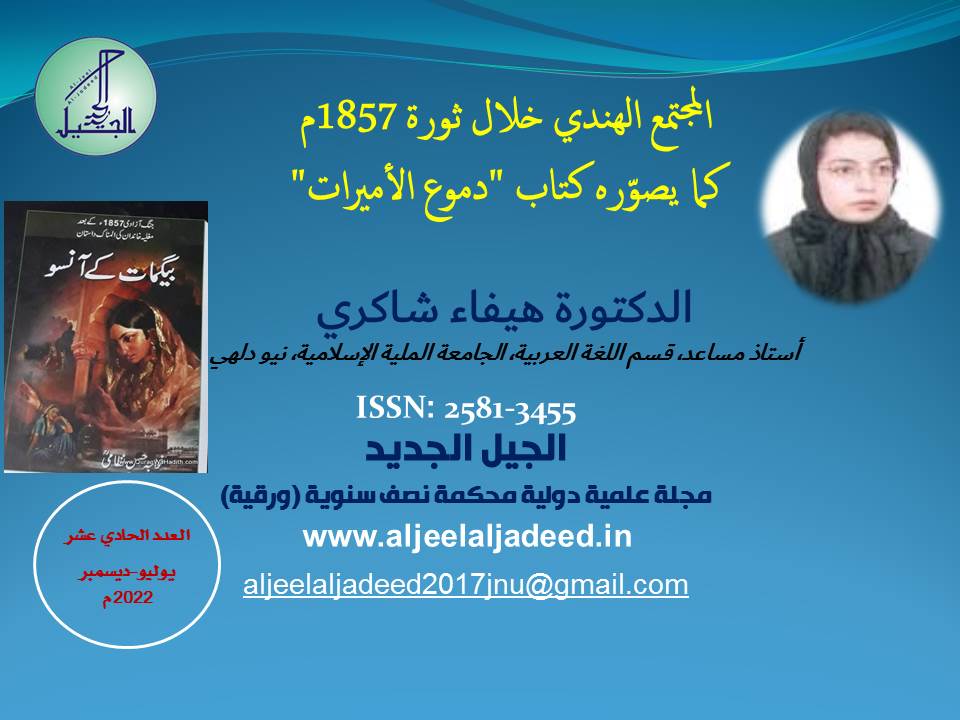أ. ساميه سالم دبيان الصبحي*
ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة البنية الزمكانية في الرواية النسائية السعودية في الفترة ما بين (2003–2013م)؛ للكشف عن أبعاد ظاهرة الاغتراب في عينة من عشر روايات نسائية سعودية. وسعت إلى تتبع البنية الزمكانية في الروايات الاغترابية وتحليل نماذج لها تكشف عن اغتراب الشخصيات وسلوكها، مستعينة بالمنهج الوصفي وفق آلياته وتقنياته التي تسهم في تحليل البنية الزمكانية ومستفيدة من الدراسات النفسية التي تكشف عن اغتراب الشخصيات. واقتضت طبيعة الدراسة أن تتكون من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. تناولتُ في التمهيد مفهوم الزمكانية، وفي المبحث الأول علاقة المكان بالشخصيات من حيث حركية المكان بين المفتوح والمغلق وتأثيره عليها، وفي المبحث الثاني علاقة الزمان بالشخصية المغتربة من حيث أشكال الزمن والبناء الزمني للروايات الاغترابية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج.
كلمات مفتاحية: الاغتراب، البناء الزمني، التواتر، الزمكانية.
مقدمة
نشأت الرواية في المملكة العربية السعودية متأخرة عن نظيراتها في البلدان العربية الأخرى، إلا أنها سارت بخطى متواصلة للحاق بالركب، وأسهمت التجربة الروائية في تقديم صورة الشخصية السعودية، وتصوير التحولات الكبرى، والقضايا الجوهرية في الواقع السعودي اجتماعيًّا وثقافيًّا مما أفرز ظواهر عديدة في البنية الفنية للرواية.
لذا تتطلع الدراسة إلى تحليل البنية الزمكانية في الرواية النسائية السعودية في الفترة ما بين (2003-2013م)؛ للكشف عن أبعاد ظاهرة الاغتراب التي يقصد بها: “الوضعية التي يكون فيها الإنسان مسلوب الإرادة، فاقدًا زمام التصرف والتحكم في مصيره وشخصيته، غريبًا عن ذاته، وعن مجتمعه بالمعنى الروحي، والنفسي، والاجتماعي، ومن ثم عدم قدرته على التعبير عن جوهره، وتأكيد وجوده الحقيقي، فكل أفعاله تصبح خاضعة لسلطة أقوى منه، ولكنه في الحالات كلها، نجده عاجزًا عن التلاؤم، والتكيف مع الأوضاع الاجتماعية، فينسلخ عنها، ويلجأ إلى الوحدة والانعزال”[1].
وتكمن مشكلة الدراسة في تتبع البنية الزمكانية لظاهرة الاغتراب في الروايات المعنية، وتحليل نماذج اغترابية تكشف عن اغتراب الشخصيات، منطلقةً من فرضية مفادها: وجود علاقة بين بنية المكان والزمان واغتراب الشخصيات الروائية، ولذلك سعت الدراسة إلى تجلية طبيعة العلاقة من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:
– كيف وظفت الروائية السعودية البنية الزمكانية لظاهرة الاغتراب؟
– ما مدى تأثير الأمكنة الاغترابية في نفسية الشخصيات؟
– ما مدى تأثير الزمان في تحديد مصير الشخصيات الاغترابية ؟
وتهدف الدراسة إلى الإسهام في إثراء الدراسات السردية والنقدية في الأدب السعودي، والوقوف على تأثير البنية الزمكانية في اغتراب الشخصيات وسلوكها.
يعد مصطلح “الزمكانية” من المصطلحات المنحوتة، وهو مركب من مصطلحين الزمان والمكان. وهو مصطلح غربي اشتق من اللفظ اللاتيني (Chronotope)، الذي يعبر عن الزمان بـ(Chroonos) والمكان بـ(Topes) فظهر المصطلح عند تركيبهما، وما ترتب على ذلك من توسع في دلالة المصطلح[2].
وقد عرف الناقد الأمريكي “جيرالد برنس” مصطلح (Chronotope) بقوله: “السّمة الطبيعية لعلاقة تربط بين الزمان والمكان، مؤكدًا الاعتماد التام المتبادل بينهما، يعني حرفيًّا الزمان والمكان”[3].
ويشار إلى أن “ميخائيل باختين” من أوائل من استخدم مصطلح الزمكانية الذي يقيد ارتباط الزمان والمكان داخل الرواية؛ حيث قال: “ومن وجهتنا سوف نطلق على العلاقة المتبادلة الجوهرية بين الزمان والمكان المستوعبة في الأدب استيعابًا فنيًّا اسم (Chronotope)، مستوعبًا لمجموع خصائص الزمن، والفضاء داخل كل جنس أدبي، عبر انصهار علاقات المكان، والزمان… وهذا الامتزاج بين العلاقات وهو الذي يميز الزمكان الفني”[4].
علاقة المكان بالشخصيات المغتربة
يعد المكان البؤرة الأساسية للعناصر الروائية الأخرى، فالمكان ليس “عنصرًا زائدًا في الرواية، فهو يتخذ أشكالاً، ويتضمن معاني متعددة، بل إنه قد يكون في بعض الأحيان، هو الهدف من وجود العمل كله”[5].
فالمكان ليس شيئًا هندسيًّا، وديكورًا مجردًا، وإنما يحمل في طياته معانيَ اجتماعية ونفسية مرتبطة بالشخصيات؛ أي أنه في أغلب الأحيان تقوم الشخصية بـ”إسقاط الحالة الفكرية أو النفسية للأبطال على المحيط الذي يتواجدون فيه، مما يجعل للمكان دلالة تفوق دوره المألوف، كديكور، أو كوسط يؤطر الأحداث”[6].
بهذا المفهوم يتضح ارتباط عنصر المكان بالشخصيات، بل إنّ كلاًّ منهما يؤثر ويتأثر بالآخر؛ فالشخصية هي التي تعطي المكان قيمة، بالإضافة إلى أنه “قادر على أن يمنح للأمكنة أبعادها الذهنية، وقادر أيضًا على تغيير ملامحها، وتشكيلها وفق أنماط مختلفة”[7].
فالعلاقة بين المكان والشخصية علاقة قائمة على الاندماج التام؛ لأن كلاًّ منهما يحضر عند حضور الآخر، فالمكان بما يحمله من معانٍ نفسية، واجتماعية يعبر عن سلوك الشخصية، والشخصية تتقمص صورة المكان،”ويصبح سلوكها ترجمة لسلوك المكان، ولغتها من لغة المكان”[8].
فالأماكن الموصوفة التي ارتبطت بالشخصيات الاغترابية داخل الروايات بما تحويه من علامات ساعدت على تعزيز الاغتراب لدى الشخصيات؛ لأن المكان يفسر ما يجول في نفسيات الشخصية من عواطف، ومشاعر، وأزمات؛ أي أنه “يعكس حقيقة الشخصية، ومن جانب آخر إن حياة الشخصية تفسرها طبيعة المكان الذي يرتبط بها”[9]، وللمكان أثر بارز في العملية الاغترابية؛ حيث أسهم في “إحداث رؤية واعية لعذابات الروح ومعاناتها عبر رحلتها في هذا الكون؛ إذ أحدث المكان في كيان ]الشخصية[ فجوة نفسية، وحرقة مؤلمة، عبرت عن الواقع غير المنسجم مع الذات؛ إذ نلمس خلف أستار المكان صيحات دفينة توحي بمعاناة التوتر، والاضطراب، والقلق”[10].
حركية المكان الاغترابي بين المفتوح والمغلق
الأماكن المفتوحة
هي “حيز مكاني خارجي، لا تحده حدود ضيقة بحيث يشكل فضاء رحبًا، وغالبًا ما يكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق”[11]، مثال ذلك: المدينة، والقرية، والشوارع.
وقد حظيت الروايات الاغترابية -المعنية بالدرس- بالأمكنة المفتوحة التي عززت من مدى اغتراب الشخصيات، فشخصية “ريم” في رواية “حين رحلت” وصفت مدينة الرياض بأنها مدينة خانقة، يملؤها الشوك، ويكسوها الحزن، وتبث الخوف. فقد جاء على لسان الشخصية عبر استخدام المونولوج الداخلي:
“حين زرت الرياض بعد رحيلك وجدتها موشُومة بك… يكسوها حزنٌ مريب، في شوارعها تُشاهدُ جفافًا يكاد يزرعُ الشّوك في عينيك… عرفت كيف تحتال المدينة على كبدها، وأجهزة الرقابة فيها، ومثاليتها المُدّعاة، أيقنت تمامًا بأنها مجرّد عاهرةٍ ترتدي عباءة على الرأس وقفازين وتصلّي وهي على جنابة!… إنها مدينةٌ خانقة”[12].
فالشخصية لم تشعر بالسعادة، والطمأنينة، والأمان لمدينة الرياض؛ لعدم تكيفها مع القيود التي يضعها المجتمع؛ فهو مكان يظهر الصلاح، ويبطن الفساد؛ أي أنها مصدر التناقضات. وكذلك الحال مع مدينة بريدة، فهي الأخرى مكان تنفر منه الشخصية ذاتها رغم أنها مسقط رأسها، ومكان قضت طفولتها فيه؛ بسبب ما تلقته من العنف الأسري، والعنف المجتمعي، فأصبح مكانًا تنفر منه. فخلّصت ذاكرتها من ذكريات مدينتها العجوز:
“كانت بريدةُ وجهًا مُتخشّبًا كوجهِ عجوزٍ مُصابةٍ بشللٍ رباعيّ وتنتظرُ الموت أمام نافذةٍ مُغلقة لم تترك بروحي أي شيءٍ منها، فهي مدينة لا لحنَ فيها، ولا غناء، ولا نساء، فكيف احتملت نفسها؟!”[13].
فـ”بريدة” في نظر الشخصية مدينة بائسة تضع القيود دون الاهتمام برغبات نسائها! وهذا ما زاد من تعميق شعور الشخصية باغترابها. وهو الشعور ذاته الذي انتاب “سارة” في رواية “عيون قذرة” تجاه مدينة الرياض خاصة “حي السلام”، فهو الآخر كان حيًّا منفرًا؛ بسبب ما عانته فيه. جاء وصفه على لسان الراوي العليم:
“ذلك الحي الذي نشأت فيه، وتيتمت، وتعذبت، وذقت فيه طعم الهوان، والألم، والوحدة”[14].
فارتبط هذا الحي بالذكريات المؤلمة القاسية لدى الشخصية التي تعبر عن الألم النفسي الذي يكمن في داخلها.
كما تمثل مدينتا “مكة وجدة” عند “حسين” في رواية “ملامح” مكانًا طاردًا؛ فيقرر الهجرة إلى لندن، هاربًا من أوجاعه، وذكرياته المؤلمة، يقول مصورًا رحلة الرحيل: “قبل سنوات طويلة، هجرت مكة إلى جدة، عزمت لحظة رحلت عن مكة، أن ألقي بحمولة أوجاعي في واحد من أوديتها السحيقة، طاردًا عن جسدي كل العذابات التي تجرعتها من حرمان وحسرات، وأتحرر من العقد المتراكمة في داخلي، وها أنا أعود ثانية، أقرر الرحيل، لكن إلى مكان بعيد، لا ترصدني فيه العيون، ولا تحاصرني الألسن بالسؤال إلى بقعة، لا يملك ماضيَّ القدرة على عبور المحيطات…”[15].
فالشخصية تحاول الهروب من المكان؛ لأنه كان باعثًا لذكريات ذلك المكان والمشاعر الداخلية، من آلام الماضي وما يحمله من التوتر والقلق، بالإضافة إلى ما تعيشه الشخصية من عدم التكيف مع واقعها.
وفي رواية “البحريات” تمثل مدينة بيروت أحد الأمكنة الطاردة لـ”رحاب”، بعد أن فشلت في علاقتها مع “علي”، وفشا أمرها بين النساء، فأصبحت بيروت بما فيها من شوارع مكانًا خانقًا مليئًا بالذكريات الحزينة: “حينما كانت تفر من المكان، كانت تفر من هشيمها وركامها، ظنت أن القضية أزمة مكان، وأزمة هذا الشارع الطويل في (بيروت)… ولكن لم تعلم أن المكان هو الواجهة الزجاجية فقط، أما الحزن فيغور بعيدًا كمعول يحفر بئرًا سحيقة”[16].
فأصبح المكان المرآة التي تعبر عما يجول في نفسية “رحاب”؛ لما له من ذكريات أليمة خلّدت في نفسها الانكسار والضعف، وهو ما توحي به عبارة (كانت تفر من هشيمها وركامها)؛ فساعد المكان بما يحمله من ملامح على تعزيز اغتراب الشخصية.
إن مشاعر النفور من المدن التي تمثل ذكريات مؤلمة للشخصيات، تتواتر في مواطن متفرقة من النماذج، فـ”سعاد” في رواية “البحريات” تعبر عن غربتها في الرياض، وما يعتريها من الوحدة والخذلان فيها[17] وهي المشاعر ذاتها التي تنتاب “سديم” في رواية “بنات الرياض”، التي كانت تنفر من العيش في “مدينة الخبر” بسبب وجود “فراس” الذي ترك في نفسيتها جرحًا لم يبرَ [18].
الأماكن المغلقة
هو “الحيز الذي يحوي حدودًا مكانية تعزله عن العالم الخارجي، ويكون محيطه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح”[19]، من أمثلة ذلك: المنزل، والغرفة، والسجن. وهذه الأمكنة قد تكون جاذبة، أو طاردة حسب نفسية الشخصية الاغترابية.
وكانت الأمكنة المغلقة من أكثر الأماكن التي عززت اغتراب الشخصية، وشعورها بالوحدة، والانعزال عن العالم الخارجي. وهذا ما يظهر عند الشخصية الرئيسة في رواية “الآخرون”، فقد كانت تمارس سلوكاتها غير السوية (في الحمام)، فكانت ترى العزلة هي المكان الآمن الذي لا يستطيع أحدٌ محاسبتها؛ حيث جاء على لسانها: “أنتقل إلى عالم أعلى، أغيب، وأتتبع دهاليز وبوابات وممرات سريّه لا توجد إلا في عقلي، أتتبع تفاصيلها ومنعطفاتها؛ محاولة أن ألتصق بها، أن أفرك عليها أصابعي فأجلو حقيقتها…”[20].
فأصبح الحمام هو المكان الجاذب الذي تهرب إليه الشخصية؛ لتختلي بنفسها، وتعيش في أوهامها[21].
بينما شكلّت الغرفة في المستشفى لدى الشخصية مكانًا طاردًا؛ لما له من ذكريات تربطها به، فهو يشعرها بالخوف والوحشة. كما أسهم اللون الأبيض -في الغرفة- في تعزيز اغترابها؛ فهو رمز للكفن خاصة بعد موت شقيقها “حسن”:
“البياض هنا لا يُحتمل! لكني أرضخُ لمشيئة محمد، وأرتدي قميصًا أبيض شبه عارٍ، وأنام في سرير بملاءات بيضاء، في غرفة جدرانها بيضاء، وستائرها بيضاء، وأبوابها بيضاء، كل شيء هنا أبيض بحدّة تجلب الغثيان، والخوف، والكوابيس القائمة! الأبيض الذي لا يمكن أن يكون إلا موتًا، وفي واحدة من هذه الغرف البيضاء نبتت لحسن جناحات وطار”[22].
كما تساعد وجود المرآة داخل الغرفة على استغراق الشخصية في أوهامها وانكشافها على ذاتها، كشخصية “طفول” في رواية “ستر” التي جعلت جسدها في المرآة شخصًا آخر تخاطبه لتعيش وحدتها أمامها. وحتى تنكشف تمامًا أمام ذاتها، تعري جسدها وتتأمل تفاصيله، قائلة:
“هنا صارت لكِ حجرة وصارت لك طفول كاملة بلا شروخ، لن تشتكي الزحام بعد الآن بقدر ما تشتكي وحدتي معك في المرآة … ومحاورة هذا الوجه في المرآة بصوت عالٍ، لا تترك على جسدها من ستائر، وتقف لمرآتها تتأمل في الحنيات”[23].
ولم يقتصر الاكتشاف على الشكل الخارجي، وإنما الولوج إلى العالم الداخلي الذي يعكس المشاعر النفسية للشخصية تجاه ذاتها من احتقار، ولوم للنفس، ومحاسبة لها. تصور الساردة تلك اللحظات من حياة “طفول” بقولها:
“شعرت بغضب يعتريها صوب صورتها في المرآة هذه التي تتخبط بين لومٍ، واحتقار، وشفقة”[24].
ويعد السجن أكثر الأماكن المغلقة اغترابًا بعدّه المكان الذي يجمع القهر، والذل، والإهانة. تعيش فيه الشخصية تحت ضغط نفسي وبدني، بالإضافة إلى أنه يقيّد حرية الإنسان ويعيد بناءه لأنه “يصبح هو السيد الذي يعيد صياغة النزيل فيه، ليس على مستوى الحيز المكاني فحسب -بما يخلفه من الشعور، ومحدودية الحركة- ولكن حتى على مستوى أنظمته وقوانينه”[25]، وفي السجن يشعر الفرد بأن الحياة ثابتة قد توقفت عن السير، وهذا ما حدث لشخصية “سارة” في رواية “نساء المنكر”، فقد وصفت الحياة داخل السجن بقولها:
“في السجن يشعر الإنسان بأن الحياة قد توقفت، والأرض لم تعد تدور، وكل شيء يتغير، حتى أنا لم أعد أتذكر ملامحي؛ إذ لا توجد مرآة يمكن من خلالها أن أستعيد ملامح وجهي التي شعرت بأنها تغيّرت…”[26].
وتعد الأبواب والممرات من الأمكنة التي تعزز إحساس الشخصية بالضياع، والرهبة داخل السجن؛ حيث إنّ “حركة انغلاق الأبواب وانفتاحها، وطنين المفاتيح في الأقفال يمكنها أن تشكل موضوع رهبة”[27] داخل نفسية السجناء وهذا ما وصفته الشخصية بقولها:
“طارت ساقاي مع هرولتي في ذلك الممر الطويل، وتحولت عتمة ذلك الممر إلى هواء أخذته بملء رئتيّ…”[28].
وباستعراض ما سبق، يمكن القول بأن للمكان أثرًا بالغًا في تعزيز اغتراب الشخصية؛ حيث كشف عن معاناتها بما حمله من ذكريات مرتبطة بها، فالأماكن حضرت بظلمتها، وصمتها، وصرامتها، وقسوتها، وضياع هُويتها.
علاقة الزمان بالشخصية المغتربة
يعد الزمن أحد الأركان المهمة في بناء الخطاب الروائي، الذي يؤثر في بقية العناصر الأخرى، بل يساعد في عملية تشكيل بنيتها السردية، فهو ينظم البناء السردي؛ لأن أية رواية لا بد أن تحتوي على زمن إما ماضٍ، أو حاضر، أو مستقبل[29].
ويعد الزمن أحد المحاور التي تُشكّل ظاهرة الاغتراب، بعدّه “قوة فاعلة ومؤثرة في الإنسان، وذلك من خلال فقدان التوافق النفسي والانسجام الذاتي مع اللحظة التي يحياها الفرد”[30]، فعندما تفقد الشخصية إحساسها بالوجود، تبحث عن ذاتها إما بالرجوع للماضي، أو التنبؤ بالمستقبل. كل ذلك في سبيل الهروب من معاناتها، وما تشعر به من قهر، وتهميش، وعنف.
وقد وظفت الروائيات السعوديات أشكال الزمن؛ للكشف عن معاناة شخصياتهن، والأزمات النفسية التي مررن بها، كاستخدامهن الزمن المتداخل الذي يختلف فيه ترتيب الأزمنة عن الوضع الطبيعي: الماضي، والحاضر، والمستقبل؛ بحيث ينتقل الراوي بين الأزمنة دون أن يلتزم بتسلسل الأحداث بشكل منطقي[31]، وهو ما ظهر جليًا عند “قماشة العليان” في رواية “عيون قذرة” التي بدأت باللحظة الآنية وهي وجود “سارة” في الطائرة المتجهة إلى لندن، ثم قفزت الشخصية إلى الماضي البعيد عن طريق التذكر لحدث طلاق والديها وهي في مرحلة الطفولة؛ لتعود للحاضر مرة أخرى بلقائها بأخيها، ثم تعرج ثانية إلى الماضي، وتسترجع لحظات زواج والدتها بعد انفصالها عن والدها، لتدخل بعد ذلك في حوار داخلي مع أخيها “فيصل”. وتدخل الشخصية في تداعيات زمنية متفاوتة بين ماضيها وحاضرها، حتى تصل بنا إلى زواجها من ابن عمتها، وهي حركة يمكن تمثلها من خلال الخطاطة الآتية:
شكل (1) سير النظام الزمني في رواية “عيون قذرة”
فالشخصية رغم وجودها في الحاضر إلا أنها تعيش في الماضي بما فيه من صدمات نفسية، وأزمات، وقهر، وحرمان في محاولة البحث عن حلول لحاضرها ومستقبلها. وهذا يعكس أيضًا “مدى التشتت والاضطراب الذهني الذي تعيشه الشخصية”[32].
وباستقراء نماذج سير الزمن في الروايات الاغترابية يمكن استخلاص الحركة الزمنية في الروايات عبر ثلاث مجموعات:
أولاً: الزمن الطبيعي، هو الزمن الذي يسير في اتجاه واحد من الماضي إلى المستقبل، بحيث يكون سهم الزمن بحالة طبيعية[33]، وقد يوحي هذا الزمن إلى وعي الشخصية بمعاناتها بشكل يجعلها تتحكم في لغة القص. وقد برز هذا النوع في روايات “بنات الرياض”، و”نساء المنكر”، و”حين رحلت”، و”الآخرون”، الذي يمكن تمثله في الشكل الآتي:
شكل (2) سير الزمن الطبيعي في الروايات الاغترابية
ثانيًا: الزمن المتداخل، هو ما اختلف فيه ترتيب الأزمنة عن الوضع الطبيعي الماضي، والحاضر، والمستقبل؛ بحيث ينتقل الراوي بين الأزمنة دون أن يلتزم بتسلسل الأحداث بشكل منطقي[34]، وهو ما يتناسب مع الحالة النفسية التي تمر بها الشخصية المغتربة من ارتهان للماضي حينًا والضبابية حينًا آخر. ويظهر هذا النوع في روايات “البحريات”، و”ملامح”، و”جاهلية”، و”عيون قذرة”، الذي يمكن تمثله من خلال الشكل الآتي:
شكل (3) سير الزمن المتداخل في الروايات الاغترابية
ثالثًا: الزمن الدائري، وهو “الزمن الذي يبدأ من نقطة معينة لينتهي عند النقطة نفسها”[35]، فعلى سبيل المثال: إن كان الزمن في بداية الرواية قد بدأ بزمن الماضي فإنه يتوقف في نهاية الرواية عند الزمن ذاته، وهو ما يعزز شعور الفشل عند الشخصية. ويظهر في روايات “ستر”، و”سفينة وأميرة الظلال”، ويمكن تمثله من خلال الشكل الآتي:
شكل (4) سير الزمن الدائري في الروايات الاغترابية
وبناءً على ما سبق، يمكن القول بأن الروائيات السعوديات، وظفن الحركة الزمنية في الروايات الاغترابية بما يتوافق مع الحالة النفسية للشخصيات الاغترابية؛ وبصورة تجعل من الزمان تقنية تسهم في رسم معالم الاغتراب عند الشخصيات.
البناء الزمني في الروايات الاغترابية
لبنية الزمان أثرٌ مهمٌ في تعزيز إحساس الشخصية بعدم تكيفها مع الواقع من خلال التلاعب في الأزمنة، وتداخلها. ويمكن النظرُ إلى أقسام البناء الزمني في الروايات الاغترابية على النحو الآتي:
التواتر النمطي
يقصد به: “حالة التكثيف السردي للزمن الطويل الممتد، الذي تشعر به الذات، لكن السارد يختزله في العملية السردية في جمل، أو فقرات، أو تعبيرات موجزة. ويقترن بالأحداث النمطية في الرواية، وهي الأحداث المألوفة التي مرت بها الذات كل يوم، وكل أسبوع، أو كل شهر…”[36]، بمعنى أن الشخصية الاغترابية تؤمن باستمرارية معاناتها الدائمة دون تغير يذكر طوال الأيام، أو الأسابيع، أو الشهور.
ويظهر التواتر النمطي في رواية “ملامح” على لسان “ثريا” التي عانت من ألم فراق ابنها بعد أن نفاه والده إلى الأردن، فظلت شهورًا متتابعة تبكيه وتسترجع ذكرياتها معه، كما عزز الفعل “ظل” الاستمرارية الدائمة لمعاناة الشخصية:
“ظللت أشهر أبكي، كلما دخلتُ غرفته أضمّ ملابسه، وأشمَّ رائحته فيها، أتخيّله في سريره نائمًا، أتذكّر مشاهد ولادته، أول مرة حبا فيها، أول مرة نطق فيها كلمة ماما، صراخه في أرجاء البيت”[37].
وفي موضع آخر تصف معاناتها النفسية تجاه وضعها المادي، والمعنوي، وتحطم طموحاتها في الزواج:
“كان قد مر عامان على زواجي من حسين، مطلع كل يوم، لا أكف عن سؤال نفسي! هل أنا سعيدة؟ هل هذه هي الحياة التي كنتُ أحلم بها؟ هل توقف طموحي عند حدود هذه الشقة الضيقة، والأثاث الرخيص؟”[38].
كما جاء التواتر النمطي في رواية “الآخرون” كاشفًا معاناة الشخصية الرئيسة مع مرضها الذي تحاول إخفاءه عن أعين الناس؛ لأنّ لمرضها سمعة سيئة في نظرهم، وعيبًا يجب إخفاؤه:
“دومًا كان مرضي سرًّا، ولفترات طويلة، كان مجرد الحديث عنه فعلًا شائنًا يستوجب الزجر في منزلنا، كأن المرض ذنبٌ بلا مغفرة، وعيب يجب إخفاؤه…”[39].
والملاحظ أن الروائية قد اختزلت كثيرًا من المشاهد في بعض الألفاظ والتعابير كـ(دومًا) و(لفترات طويلة)؛ لينعكس ذلك على المدة التي استغرقتها الشخصية مع معاناتها؛ حتى أصبحت تدعو الله قبل نومها ألا ينفضح أمرها:
“كل ليلة، كان دعائي الأخير قبل أن أغمض عيني ألا يُفتضح أمري، ألا أمر تحت مقصلة الشفقة، ألا تزج بي نوبتي في متاهة العطف المرهق…”[40].
كما ساعد التواتر النمطي في رواية “نساء المنكر” على الكشف عن الحالة النفسية التي تمر بها الشخصية، فـ”سارة” بعد أن زُجَّ بها في السجن، أصبحت تمر عليها الأيام دون معرفة مصيرها؛ فتسوء أحوالها النفسية؛ حيث وصفت حالها قائلة:
“كلما مرّت الأيام، وأنا لا أعرف أية جريمة ارتكبت، ولا أي عقاب سينالني، ساءت أحوالي النفسية أكثر وأكثر“[41].
فعبارة “كلما مرّت الأيام” تدل على التواتر النمطي المشبع بالقهر، والتهميش. كما تقاطعتْ شخصية “سارة” مع شخصية “مالك” في رواية “جاهلية” الذي اعتاد على سماع عبارة (يا أسود) من البائع الباكستاني[42].
ويبرز التواتر النمطي في رواية “حين رحلت” في اختزال “ريم” معاناتها من بعد زواجها الإجباري من أبي حامد الرجل المسن في عبارات مختصرة مثل (قضيت أكثر من ست سنوات) معبرة عن المدة المستغرقة في استمرارية هذه المعاناة[43].
وفي رواية “عيون قذرة” برز هذا النوع أيضًا في معاناة “فيصل” بعد انتهاء علاقته بـ”كاتيا”، وانكشاف أمر خيانتها له:
“مرت أيام طويلة كنت فيها أغرد خارج السرب.. ميتًا يعيش على قيد الحياة”[44].
فاختزال الزمن -هنا- جاء معبرًا عن الحالة النفسية التي يمر بها “فيصل” في عدم إحساسه بالوجود يتجرع مرارة الخيانة، في حين جاء الزمن ثقيلًا طويلًا على “فيصل” الطفل الصغير بعد الوداع الأخير من “ليلى”:
“ليالٍ طويلة قضيتها باكيًا منتحبًا أخشى ألا أراها بعدها أبدًا”[45].
وهذا الشعور النفسي الذي يعتري “فيصل”، يظهر عند “مريم” في رواية “ستر” بعد فقدانها حملَها، وإحساسها بالفراغ داخل حوضها طيلة أسبوع كامل[46].
وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن الشخصيات قد تلجأ إلى اختزال الزمن في عبارات تكرارية؛ لتعكس مدى إحساسها بالفشل، والضياع، واستمرارية آلامها غير المتناهية.
القفز الزمني
يقصد به: “الانتقال فجأة من حدث معين إلى حدث آخر بينهما مسافة زمنية معينة”[47]، سواء أكان الانتقال عن طريقة الإشارة الزمنية أو عدمها، وهو في كل الأحوال يفهم من سياق الأحداث[48].
ويظهر القفز الزمني في رواية “عيون قذرة” في مشهد وجود “سارة” في الطائرة المتجهة إلى لندن لتعود الشخصية بذاكرتها إلى الوراء باستخدام تقنية “الاسترجاع”[49] لحظة انفصال والديها، فقد عبرّت عن ذلك باستخدامها المونولوج الداخلي:
“تلبستني الطفلة اللاهية في أعماقي، وهي تفتح عينيها على النهاية المفجعة بين والديها.. لم تسمع سوى الصراخ، ولم تر إلا الدموع.. تتكوم وشقيقها الأكبر في حجرة من حجرات المنزل ليتلقيا أول جرعات الحياة صراخًا، وضربًا، وبكاءً، ونحيبًا…”[50].
ثم تعود الشخصية مرةً أخرى إلى زمنها الحاضر لحظة سؤال المضيفة، وهو: “هل يوجد من ينتظرك في الخارج؟.. لقد غادر الجميع الطائرة عداك..”[51].
فكان القفز الزمني من الحاضر إلى الماضي “مرحلة الطفولة” يعود لتلك اللحظة التي تعرضت فيها الشخصية لصدمة نفسية، تركت أثرها في ذهن الشخصية. وفي موضع آخر عادت الشخصية ذاتها إلى الوراء، وهي في التاسعة من عمرها لحظة تفوقها الدراسي، وهي اللحظة التي خذلت فيها من والدتها، وعمتها، وزوجة أبيها:
“في التاسعة من عمري كنت.. ولشقائي وألمي كنت إحدى المتفوقات في المدرسة.. قالت لي المعلمة: لتحضر والدتك غدًا حفل المتفوقات، وستلبسينها عقد الورود هذا.. حارت طفولتي وحرت معها أي أمٍّ فيهن التي ستحضر حفل تفوقي، وستفرح لنجاحي، وسأطوقها عقد محبتي؟…”[52].
وفي نهاية الأمر، وقفت بين جموع الطالبات يغشاها الخذلان، والانكسار، ويملؤها الحزن، ويخلد هذا الموقف في ذاكرتها، فلم تحضر أيّ منهنّ. فعودة الشخصية في أغلب الرواية إلى أحداث ماضية يكشف لنا عن موقف الشخصية من ماضيها الأليم؛ الذي هو أساس اغترابها.
وقد يكون القفز الزمني نحو المستقبل باستخدام تقنية “الاستشراف”[53]؛ كما جاء في رواية “جاهلية” في مشهد اعتداء “هاشم” على “مالك” وهروبه إلى والدته. فكرت “لين” في “مالك”، ثم نظرت إلى تعامل أمها مع ابنها المدلّل، وقالت باستخدام المونولوج الداخلي:
“إن مات سيموت هو أيضًا، أجل سيقتصّون منه، وعندما يشيع الخبر سيتقوَّل الناس كثيرًا، وسيكون قد أضاف إلى السوء الذي ارتكبه سوءًا آخر: الفضيحة! … إن مات ستموت أمّه. لقد جعلت منه عمود حياتها، … لكنّها لم تدرِ بعد ما الذي فعله … وحتى إن عرفت فستفهم لِمَ فعل ما فعل، وتسامحه”[54].
فدلت الأفعال (سيموت، سيقتصّون، سيتقوَّل، سيكون، ستموت، ستفهم) على القفز الزمني من الحاضر إلى المستقبل كنوع من تنبؤ الشخصية بما سيحدث من ردة فعل والدتها والمجتمع.
وهذا النوع قليل في الروايات المعنية بخلاف تقنية الاسترجاع التي برزت في غالبيتها. فالقفز إلى الماضي يعبر عن مدى التردد، والقلق، والحيرة الذي تعيشه الشخصية، كما أنه قد يكون “محاولة إثبات الحقائق وتصريحها زمنيًّا كنوع من الاعتراف من ناحية، والإدانة من ناحية أخرى”[55]، وكأن الماضي بما فيه من ذكريات هو المسؤول الأول عن معاناتها.
التوافق الزمني
يقصد به “توافق الحالات الشعورية والنفسية للسارد، أو الشخصية الروائية مع زمن الأحداث المسرودة؛ إذ إننا نجد توافقًا بين الإيقاع الزمني للحدث، وبين الحالات الشعورية والنفسية للذات الروائية، وذلك من حيث سرعة الإيقاع وبطئه”[56].
وقد حظيت الروايات الاغترابية -المعنية بالدرس- ببعض المشاهد الروائية التي يتفق فيها الزمن مع الحالة النفسية للشخصية، من ذلك ما ظهر في رواية “نساء المنكر” من توافق شعور الشخصية “سارة” مع الزمن؛ حينما عبرت عن وضعها داخل السجن، وما تحمله النفوس من جروح وآلام:
“صباح الجمعة كان واضحًا من بدايته. كانت السماء ملبدّة بالغبار، والنفوس تزدحم بالجروح والآلام، وعندما سمعت صوت الجرس الخارجي شعرت بشيء ما يجثم فجأة على صدري”[57]، فالشخصية تشعر بعدم صفاء أيامها المليئة بالأحزان، والآلام، كصباح الجمعة المليء بالغبار.
كما يبرز هذا التوافق في رواية “ملامح” الذي يعبر فيها الزمن عن الحالة النفسية التي يمر بها “حسين” بعد طلاقِه “ثريا”؛ فقد كانت أول ليلة من فراقها ثقيلة وبطيئة على “حسين”:
“الليلة الأولى التي خلا فيها البيت من ثريا، كانت بالنسبة إلى ثقيلة، عدتُ يومذاك عند منتصف الليل، قادتني خطواتي إلى غرفتها…”[58].
وفي رواية “ستر” جاء الزمن متوافقًا مع الحالة النفسية لـ”مريم”، وما تشعر به من وحدة، وضياع، وحزن تجاه واقعها بعد انفصالها عن زوجها “بدر”:
“جَلَسَتْ مريمُ في عتم حجرتها تتتبع تَكَّات العقرب في وحدته… عقدة من الوقت وَقَفَتْ في شريانها الأورطي وتَجَلَّط فيها بدر، يوم أو مائة تمضي لا يهم لولا هذا التجويع، هذا البتر عن جذع بدر، لا يجري الوقت إلا حين تُسابقه داخلنا رغبة، أو جُرح، أو حلم، وإلا تَحَجَّر الوقتُ ومات، خارج السباق لا حياة للزمن”[59].
فجاء الزمن هنا متوافقًا مع الحالة النفسية التي تمر بها “مريم” بعد طلاقها، فبطء سير عقارب الساعة، والصوت الصادر منها بوحشته، يتوافق مع الهدوء والوحدة التي تعيشها الشخصية، ومن ثم سيره بشكل طبيعي مرتبط برغبات الشخصية وأحلامها، وإلا توقف الزمن وانتهى.
التوقف الزمني
يقصد به: “شعور الذات الساردة، أو إحدى الشخصيات، أو مجموعة من الشخصيات الروائية بتوقف الزمن، نتيجة وقوع حدث مفاجئ له تأثيره المباشر على الشخصية؛ فتشعر الذات أو الشخصية أن الزمن قد توقف تتابعه عند هذا الحدث”[60].
ففي رواية “ستر ” تعرضت “مريم” لصدمة رؤيتها “زايد”، وهو ضمن منظمة إرهابية قررت التفجير أمام المحكمة؛ حيث جاء على لسان السارد:
“توقف الزمن برأس مريم، تمددت اللمحةُ وبقلبها كان ذاك الوجه يطير في الهواء… الدوي اجتاح بوابة المحكمة”[61].
ولم تكن “سارة” في رواية “ستر” أحسن حالًا، فهي الأخرى شعرت بتوقف الزمن داخل السجن؛ نتيجة إحساسها بفقدان آمالها، وطموحاتها المستقبلية التي باءت بالفشل على أرض الواقع:
“في السجن يشعر الإنسان بأن الحياة قد توقفت، والأرض لم تعد تدور، وكل شيء يتغير، حتى أنا لم أعد أتذكر ملامحي؛ إذ لا توجد مرآة يمكن من خلالها أن أستعيد ملامح وجهي التي شعرت بأنها تغيّرت، وكثيرًا ما كنت أتحسس وجهي بيدي لأتأكد منها”[62].
فتوقف الزمن يعطي إشارة إلى توتر الشخصية، وانكسارها، وهزيمتها النفسية أمام واقعها نتيجة صدمة تعرضت لها؛ لأن التوقف بمثابة إعلان الانتهاء، ودلالة على عدم استمرار الحياة وسيرها.
خاتمة البحث
اهتمت هذه الدراسة بتحليل البنية الزمكانية في الروايات النسائية السعودية في الفترة ما بين (2003-2013) للكشف عن ظاهرة الاغتراب في عينة من عشر روايات، وخلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها:
- كشفت البنية المكانية عن علاقة الفرد بالمكان؛ حيث مثلت بعض الأماكن كـ (الحمام- والأماكن خارج الحدود) بيئات جاذبة، بينما مثّلت أماكن أخرى كـ (المدينة-الغرفة) بيئات طاردة للشخصيات المغتربة، وتوقف ذلك على تجارب الشخصيات وذكرياتها.
- حاولت الروائيات -في الروايات المعنية- التعبير عن الحياة الداخلية، والأزمات النفسية التي تحيط بالشخصيات بلغة تتسم بالغموض، وانعدم التسلسل المنطقي للحركة الزمنية بما يتناسب مع تدفقات تيار الوعي وضبابية الرؤى، والمشاعر.
- عبرت الشخصيات المغتربة في الروايات المعنية عن رفضها لواقعها الحاضر، فلجأت في كثير من الأحيان إلى عالم الأحلام والهذيان، الذي عكس المشاعر المضطربة تجاه نفسها وواقعها.
وختاما آمل أن يكون ما طرحته قد أسهم في تقديم قراءة نقدية اجتماعية للمنجز السردي للروائيات السعوديات. وما هو إلا جهدٌ يضاف إلى جهود الدراسات السابقة في رسم أبعاد واقع الرواية النسائية السعودية.
*كلية اللغات والترجمة، جامعة جدة، المملكة العربية السعودية.
[1] بوطارن، الهادي محمد. الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي، ط1. القاهرة: دار الكتاب الحديث، 2010م، ص:50.
[2]الأحمد، فيصل. المكان في الرواية الجزائرية، رسالة ماجستير غير منشورة. قسنطينة: جامعة منتوري، د.ت، ص:18.
[3] برنس، جيرالد. قاموس السرديات، تر: السيد إمام، ط1. القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات، 2003م، ص:32.
[4]باختين، ميخائيل. أشكال الزمان والمكان في الرواية، تر: يوسق الحلاق،ط1. دمشق: وزارة الثقافة، 1990م، ص:5-6.
[5] بحراوي، حسن. بنية الشكل الروائي (الفضاء–الزمن– الشخصية)، ط1. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1990م،ص:33.
[6] لحمداني، حميد. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط4. بيروت: المركز الثقافي العربي، 2015م، ص:71.
[7]صالح، صلاح. قضايا المكان الروائي، ط1. القاهرة: دار شرقيات، 1997م، ص:136.
[8]حسين، خالد. شعرية المكان في الرواية الجديدة، ط1. الرياض: مؤسسة اليمامة، 1421هـ، ص:104.
[9] قاسم، سيزا. بناء الرواية –دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ–، ط1. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984م، ص:84.
[10]الفلاحي، أحمد علي إبراهيم. الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري (دراسة اجتماعية نفسية)، ط1. الفلوجة: دار الغيداء، 2013م، ص:85.
[11] عبود، أوريدة. المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ط1. الجزائر: دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 2009م، ص:51.
[12]مرضي، سهام. حين رحلت. ط1. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون،2011م، ص:16-17.
[13] مرضي، سهام. حين رحلت. ص:13.
[14] العليان، قماشة. عيون قذرة، ط5. بيروت: دار الكفاح، 2014م، ص:192.
[15] حفني، زينب. ملامح، ط3. بيروت: دار الساقي،2006م، ص:99-100.
[16] خميس، أميمة. البحريات، ط5. دبي: دار مدارك للنشر، 2014م، ص:134-135.
[17] المصدر نفسه، ص:203-269.
[18]الصانع، رجاء. بنات الرياض، ط4. بيروت: دار الساقي، 2006م، ص:237.
[19]عبود، أوريدة. المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية. ص:58.
[20]الحرز، صبا. الآخرون، ط1. بيروت: دار الساقي،2006م، ص:40.
[23] عالم، رجاء. ستر، ط2. بيروت: المركز الثقافي العربي،2007م، ص:181.
[24] المصدر نفسه، ص:182.
[25] النابلسي، شاكر. جماليات المكان في الرواية العربية، ط1. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1994م، ص:317.
[26]المقرن، سمر. نساء المنكر، ط3. بيروت: دار الساقي،2008م، ص:58.
[27]بحراوي، حسن. بنية الشكل الروائي (الفضاء–الزمن– الشخصية). ص:57.
[28] المقرن، سمر. نساء المنكر. ص:53.
[29] بحراوي، حسن. بنية الشكل الروائي (الفضاء–الزمن– الشخصية). ص:117.
[30] الفلاحي، أحمد علي إبراهيم. الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري (دراسة اجتماعية نفسية). ص:75.
[31] يقطين، سعيد. القراءة والتجربة، ط1. الدار البيضاء: دار الثقافة، 1985م، ص:294.
[32] جريدي، سامي. الرواية النسائية السعودية: خطاب المرأة وتشكيل السرد، ط2. بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،2012م، ص:250.
[33] ميرهوف، هانز. الزمن في الأدب، تر: أسعد رزق، ط1. القاهرة: مؤسسة سجل العرب، 1972م، ص:27-73.
[34] يقطين، سعيد. القراءة والتجربة. ص:294.
[35] جريدي، سامي. الرواية النسائية السعودية: خطاب المرأة وتشكيل السرد. ص:258.
[36]مبروك،مراد عبد الرحمن. بناء الزمن في الرواية المعاصرة، ط1. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998م، ص:146.
[37] حفني، زينب. ملامح. ص:55.
[38] المصدر نفسه، ص:47.
[39] الحرز، صبا. الآخرون. ص:100.
[41] المقرن، سمر. نساء المنكر. ص:57.
[42]الجهني، ليلى. جاهلية، ط2. بيروت: دار الآداب،2008م، ص:142.
[43] مرضي، سهام. حين رحلت. ص:10.
[44] العليان، قماشة. عيون قذرة. ص:237.
[46] عالم، رجاء. ستر. ص:116.
[47]مبروك، مراد عبد الرحمن. بناء الزمن في الرواية المعاصرة. ص:91.
[48] المرجع نفسه، ص:100.
[49] الاسترجاع: “كل عودة للماضي تشكل، بالنسبة للسرد، استنكارًا يقوم به لماضيه الخاص، ويحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة”. بحراوي، حسن. بنية الشكل الروائي (الفضاء–الزمن– الشخصية). ص:121.
[50] العليان، قماشة. عيون قذرة. ص:9.
[51] المصدر نفسه، ص:11.
[52] العليان، قماشة. عيون قذرة. ص:247.
[53] الاستشراف: “القفز على فترة ما من زمن القصة، وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب؛ لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحدث من مستجدات في الرواية” وهذه الأحداث المتوقعة ليست على سبيل اليقين وإنما التوقع والانتظار. بحراوي، حسن. بنية الشكل الروائي (الفضاء –الزمن– الشخصية). ص:132-133.
[54]الجهني، ليلى. جاهلية. ص:8.
[55]جريدي، سامي. الرواية النسائية السعودية: خطاب المرأة وتشكيل السرد. ص:273.
[56]مبروك، مراد عبد الرحمن. بناء الزمن في الرواية المعاصرة. ص:107-108.
[57]المقرن، سمر. نساء المنكر. ص:65.
[60]مبروك، مراد عبد الرحمن. بناء الزمن في الرواية المعاصرة. ص:92.
[62]المقرن، سمر. نساء المنكر. ص:58.
المصادر والمراجع
- الأحمد، فيصل. المكان في الرواية الجزائرية، (رسالة ماجستير غير منشورة). قسنطينة: جامعة منتوري، د. ت.
- باختين، ميخائيل. أشكال الزمان والمكان في الرواية، تر: يوسق الحلاق، ط1. دمشق: وزارة الثقافة، 1990م.
- بحراوي، حسن. بنية الشكل الروائي (الفضاء–الزمن– الشخصية)، ط1. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1990م.
- برنس، جيرالد. قاموس السرديات، تر: السيد إمام، ط1. القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات،2003م.
- بوطارن، الهادي محمد. الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي، ط1. القاهرة: دار الكتاب الحديث، 2010م.
- جريدي، سامي. الرواية النسائية السعودية: خطاب المرأة وتشكيل السرد، ط2. بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،2012م.
- الجهني، ليلى. جاهلية، ط2. بيروت: دار الآداب، 2008م.
- الحرز، صبا. الآخرون، ط1. بيروت: دار الساقي،2006م.
- حسين، خالد. شعرية المكان في الرواية الجديدة، ط1. الرياض: مؤسسة اليمامة،1421هـ.
- حفني، زينب. ملامح، ط3. بيروت: دار الساقي،2006م.
- خميس، أميمة. البحريات، ط5. دبي: دار مدارك للنشر، 2014م.
- صالح،صلاح. قضايا المكان الروائي، ط1.القاهرة: دار شرقيات،1997م.
- الصانع، رجاء. بنات الرياض، ط4. بيروت: دار الساقي،2006م.
- عالم، رجاء. ستر، ط2. بيروت: المركز الثقافي العربي،2007م.
- عبود، أوريدة. المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ط1. الجزائر: دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 2009م.
- العليان، قماشة. عيون قذرة، ط5. بيروت: دار الكفاح،2014م.
- الفلاحي، أحمد علي إبراهيم. الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري (دراسة اجتماعية نفسية)، ط1. الفلوجة: دار الغيداء، 2013م.
- الفيصل، مها. سفينة وأميرة الظلال، ط1. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2003م.
- قاسم، سيزا. بناء الرواية –دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ-، ط1. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984م.
- لحمداني، حميد. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط4. بيروت: المركز الثقافي العربي، 2015م.
- مبروك، مراد عبد الرحمن. بناء الزمن في الرواية المعاصرة، ط1. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998م.
- مرضي، سهام،حين رحلت، ط1. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون،2011م.
- المقرن، سمر. نساء المنكر، ط3. بيروت: دار الساقي،2008م.
- ميرهوف، هانز. الزمن في الأدب، تر: أسعد رزق، ط1. القاهرة: مؤسسة سجل العرب، 1972م.
- النابلسي، شاكر. جماليات المكان في الرواية العربية، ط1. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1994م.
- يقطين، سعيد. القراءة والتجربة، ط1. الدار البيضاء: دار الثقافة. 1985م.
تحميل البحث